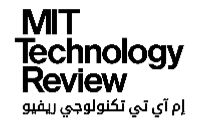في مطلع نوفمبر الماضي، هبَّت رياح عاصفة حوَّلت حريقاً شبَّ بمرج أخضر إلى جحيم كاد يأتي بالكامل على بلدة بارادَيس في كاليفورنيا، وقتل ما لا يقل عن 86 شخصاً.
وبحلول الصباح التالي، كنت أشمُّ رائحة الحريق التي وصلت حتى مسافة متر من باب بيتي في بيركلي، ومبعثها كان حريقاً على مسافة تزيد عن 200 كيلومتر. وفي ظرف أسبوع، كنت أشعر بالتهاب شديد في عينيَّ وحلقي حتى وأنا داخل البيت.
حذَّرتنا خرائط جودة الهواء من أن حالة الهواء بمنطقة الـ”باي آريا” بلغت معدلات “غير صحية للغاية”، وعلى مدار أيام كان الجميع يرتدون أقنعة وهم يتمشون بكلابهم ويركبون القطارات ويخرجون لقضاء مصالحهم. وأغلب أجهزة التنفس المصنوعة من ورق رقيق تلك لم تكن ذات فعالية حقيقية؛ إذ سرعان ما نفدت الأقنعة الجيدة –من نوع “إن-95″– من المحال التجارية، وهي الأقنعة القادرة على حجب 95% من الجزيئات الدقيقة، وكذلك نفدت من المحال أجهزة تنقية الهواء.
وراح الناس يتبادلون النصائح حول الأماكن التي يمكنهم شراء الأقنعة منها، وهرعوا إلى المتاجر التي ظهرت شائعات بوجود أقنعة جديدة فيها، وحزم آخرون متاعهم ومضوا في سياراتهم لساعات بحثاً عن مكان آمن ينتظرون فيه حتى ينتهي الأمر. وحين وصلتني الأقنعة التي طلبتها في البريد، كنت قد رحلت إلى أوهايو، إذ قررت زيارتها في عطلة عيد الشكر هرباً من الدخان.
إن التغير المناخي لا يشعل حرائق الغابات، لكنه يزيد من ارتفاع درجات حرارة الصيف ومن جفافه، وهي الظروف التي ساعدت على تأجيج نيران أكثر حرائق كاليفورنيا تدميراً وإهلاكاً للبشر.
ولطالما فهمت أن مخاطر التغير المناخي حقيقية وفي تصاعد، وقد رأيت قوة التغير المناخي بنفسي في صور جبال الجليد الذائبة وقيعان البحيرات التي جفت، وأشجار غابات سييرا التي أتت عليها خنافس لحاء الشجر. لكن هذه هي أول مرة أشمّ فيها و”أتذوق” التغير المناخي في بيتي.
ومن الواضح أن الإحساس بالتهاب الحلق وتغيير جدول رحلاتي الجوية ليس إلا أمراً تافهاً مقارنة بالأرواح التي فُقدت والبيوت التي دُمرت في حريق “كامب فاير”، لكن بعد قضائي أسبوعاً وسط سحابات الدخان، فهمت على مستوى أعمق أننا حقاً سندع الكارثة تحدث.
وسوف يتعرض الآلاف –إن لم يكن الملايين– من الناس للموت جوعاً وللغرق والاحتراق، أو سيعيشون حياة تعسة؛ لأننا أخفقنا في الاصطفاف والتعاون في وجه المأساة الكبرى التي تهددنا جميعاً. وهناك كثيرون سيضطرون إلى الإقدام على مشقة كبيرة لتحصيل مستلزمات الحياة الأساسية، وسيستمر قلقهم وترقبهم لحرائق جديدة، وأعاصير أشرس، وأيام صيفية من القيظ الشديد.
لم يعد هناك حلٌّ لمشكلة التغير المناخي، لم يبق إلا أن نحياه، وأن نبذل قصارى جهدنا للحد من الأضرار.
ومع رؤيتي لحيٍّ كامل على مقربة من إحدى أكثر مناطق العالم ثراء وقد كاد يُمحى عن بكرة أبيه، بينما أخفقت المحال التجارية في تلبية الاحتياجات الأساسية للناس في أعقاب الكارثة، فقد اعتراني إحساس بتضاؤل قدرتنا على التعامل مع التحديات الأكبر التي تنتظرنا.
معاناة
يرى بعض المراقبين أنه ما إن يتعرض العالم لعدد كافٍ من الكوارث المناخية، فسوف نرجع إلى صوابنا في النهاية ونتخذ إجراءات في اللحظة الأخيرة للتصدي للمشكلة. لكن سيكون الأوان قد فات بالنسبة للكثيرين.
وسيستغرق ثاني أكسيد الكربون سنوات ليحقق آثاره الكاملة المتصلة باحترار المناخ، وسيستمر في رفع درجات الحرارة لألف عام. فلعلنا أرسلنا إلى الهواء ما يكفي من ثاني أكسيد الكربون لتجاوز حاجز الاحترار بواقع 1.5 درجة مئوية بكثير، وبهذا المعدل الذي نسير عليه، فقد نستغرق مئات السنوات قبل أن ننتقل إلى منظومة طاقة عالمية لا تضخ في الهواء المزيد من التلوث المناخي، وكل طنٍّ من هذه الملوثات يصل إلى الغلاف الجوي يعقِّد المشكلة أكثر.
ذات مرة قال جون هولدرن (مستشار الرئيس باراك أوباما الأول للعلوم) إن خياراتنا الخاصة بالتعامل مع التغير المناخي هي إما تقليل الانبعاثات أو التكيف (أي أن نبني –على حد قوله– حواجز أعلى لصد ارتفاع مستوى سطح البحر أو أن نشيد نظم تبريد في مراكز المدن)، أو المعاناة.
وبما أننا أخفقنا تماماً في الخيار الأول، فالسيناريو المنتظر هو أحد الخيارين الأخيرين. وبما أننا حالياً نسير في طريق عدم التعامل مع الأسباب الجذرية للمشكلة، فها نحن قد اخترنا التعامل مع المشكلة عبر السيناريو الأعلى ثمناً والأقصر نظراً والأكثر تدميراً والأقسى على الإطلاق.
لقد كان بإمكاننا تغيير منظومة الطاقة، لكننا أصبحنا بصدد ضرورة تغيير كل جوانب حياتنا؛ من رفع حالة الطوارئ إلى حد بعيد، وبناء مستشفيات أكثر، وتحصين سواحلنا، وتحديث مواد البناء، وإعادة هندسة كيفية إنتاجنا وتوزيعنا لغذائنا، وجوانب أخرى كثيرة.
وحتى إذا دفعنا ثمناً باهظاً لعمل كل هذا، فسوف تكون النتيجة المتحققة أسوأ مما لو كنا تعاملنا مع جوهر المشكلة. لقد قررنا أن نُقلل إلى الأبد من جودة حياتنا، ومن إحساسنا بالأمان، مع تقليل كل فرص الحياة السعيدة والصحية. وقد فعلنا هذا بأنفسنا، ثم بأطفالنا وبالأجيال المقبلة كلها.
بلا إنصاف أو عدالة
سوف يتجسَّد الدمار الحادث جراء التغير المناخي بسبل مختلفة في الأماكن المختلفة، وبشكل غير منصف أو عادل بالمرة؛ حيث ستهب مواسم الجفاف والمجاعة الحادَّين على شتى مناطق أفريقيا وأستراليا، وسوف تتضاءل كثيراً إمدادات المياه المتاحة لمليارات البشر، ممن يعتمدون على الجليد الدائم بمنطقة التبت، وسيتزايد كثيراً خطر النزوح القسري بالنسبة للملايين المعرضين لارتفاع مستوى سطح البحر في جنوب آسيا.
وسوف تؤدي درجات الحرارة الأعلى في كاليفورنيا- مع تراجع معدلات تساقط الثلوج وتغيُّر أنماط تساقط الأمطار- إلى معيشة المزيد من الناس تحت تهديد الجفاف والحرائق.
لقد شممت ورأيت أربعة حرائق كبرى خلال العامين الماضيين؛ ففي يوليو من هذا العام، مضى صديق مقرَّب ومعه شقيقته الحامل في سيارتهما على الطريق 580، بمنطقة ممر ألتامونت، وسط ألسنة اللهب المشتعلة على جانبي الطريق، وهناك صديقة أخرى اضطرت لأنْ تهرع بسيارتها إلى بارادَيس لانتشال أبيها صباح وصول حريق كامب فاير إلى البلدة، وهناك صديق ثالث راح ينبش وسط غبار الحريق وسط بقايا البيوت بعد أيام، بحثاً عن بقايا عظام ورفات بشرية أخرى، ضمن جهود البحث والإنقاذ المحلية.
Altamont Pass fire. @sfchronicle pic.twitter.com/PBXkl6gT0E
— Erin Allday (@erinallday) July 9, 2018
لقد ضاعف التغير المناخي بالفعل من مساحة المناطق المعرضة لحرائق الغابات على مدار العقود الثلاثة الماضية فقط في الغرب الأميركي، بحسب دراسة صدرت سابقاً ضمن أعمال الأكاديمية الوطنية للعلوم. وسوف تتسع هذه الرقعة بحلول منتصف هذا القرن، بمعدل من ضعفين إلى ستة أمثال المساحة الحالية، بحسب تقييم أجرته مؤخراً هيئة تقييمات المناخ الوطنية الأميركية.
الحفاظ على النفس
لا شيء مما سبق يعد سبباً كافياً حتى نستسلم؛ إنما كان غرض ما ذكرته هو الدفع باتجاه مضاعفتنا لجهودنا، فحتى وإن لم نتمكن من “حل” مشكلة التغير المناخي، فعلينا العمل بكل قوة لإدارتها، وكأنها مرض مزمن. علينا أن نتعلم أن نتعايش مع الأعراض، بالإضافة إلى البحث عن سبل لمنع تلك الأعراض من التدهور.
إن كل جيجا-طن إضافية من الغازات الدفيئة تصعد إلى الغلاف الجوي من الآن فصاعداً لن تؤدي إلا لزيادة التكاليف الاقتصادية وحجم الدمار اللاحق بالنظم البيئية، والمزيد من المعاناة البشرية؛ لذا فالسؤال هو: ما المطلوب حتى نشهد سياسات عامة وابتكار متسارع الوتيرة وتعاون وتنسيق كافيين لإحداث تغيير سريع؟
مع تزايد صعوبة إنكار حدوث التغير المناخي، ومع شعور الناس بآثاره كتهديدات حقيقية وقائمة لسلامتهم، فإني آمل أن قادتهم والصناعات المختلفة سوف يطالبون باتخاذ إجراءات حاسمة.
لقد توصلت البحوث إلى أن التعرض لدرجات حرارة أعلى وأحداث مناخية متطرفة مرتبط بتزايد الراحة أو القلق تجاه التغير المناخي، والشباب –الذين ينظرون إلى مستقبل أشد وطأة– هم الأرجح للإيمان بأن التغير المناخي ظاهرة حقيقية وأن هناك حاجة إلى العمل، وهذه التقديرات تسري حتى على الشباب من أتباع الحزب الجمهوري في أميركا [هذه الجملة أميركية تماماً، وهذا النوع من الجمل إما أن يتم تعديل ترجمتها بما يناسب القارئ العربي، أو لا تُترجم من الأساس].
ارتباك
لكن مع مشاهدتي لارتفاع عدد القتلى من الحرائق المتزامنة عبر ولاية كاليفورنيا الشهر الماضي، طرأ على ذهني احتمال قائم ومعقول؛ هو أن الدمار الذي يحدث جراء التغير المناخي سوف يؤدي إلى إرباك المجتمع بسبل تجعلنا أقل قدرة على بذل التضحيات اللازمة لتحقيق مستقبل أكثر أمناً.
فمن المُرجح أن نواجه انكماشاً اقتصادياً، وارتفاعاً هائلاً في تكاليف التأهب للطوارئ، وسعراً فلكياً لإجراءات التكيف مع التغير المناخي (من قبيل بناء حواجز للتصدي لارتفاع مستوى سطح البحر)، كل هذا ونحن ما زلنا في حاجة إلى التسابق نحو تقليص الانبعاثات لدرجة الصفر، في أسرع وقت ممكن.
وقد يبحث الناس أكثر وأعمق عن حلول تكيفية قادرة على تحسين أماننا حالياً، لكن العائد المنتظر لاستثماراتنا في تقليل الانبعاثات قد يتضاءل مع زيادة تطرف المناخ وزيادة تكاليف الكوارث المناخية التي ستحدث. السبب –مرة أخرى– هو أن ثاني أكسيد الكربون يتحقق أثره بعد مرور فترة طويلة، ولن تكف المشكلة عن التدهور –ناهيك عن اختفائها– إلا عندما نصل إلى معدل صفر في الانبعاثات (ما لم نتوصل أيضاً إلى طريقة ما لامتصاص كميات مهولة من ثاني أكسيد الكربون من الهواء).
ومع إنفاق المزيد والمزيد من نقودنا ووقتنا وطاقتنا على المتطلبات الفورية للمآسي الكثيرة والمتداخلة التي تحدث، فإني أخشى أن يصبح الناس أقل قابلية لاستثمار مواردهم -التي ستتضاءل مع مرور الوقت- من أجل تحقيق الصالح العام على المدى البعيد.
بمعنى آخر: من آثار التغير المناخي المحيِّرة هو أنه قد يؤدي إلى تقليل إقبالنا على التصدي له.
الأسوأ قادم
عندما بدأت في الكتابة بجدية عن التغير المناخي قبل أكثر بقليل من خمس سنوات، كانت مخاطره تبدو بعيدة ومُجردة، وفي أغلب تلك الفترة كنت أفترض -دون أن أدري- أننا سنواجه المشكلة في نهاية المطاف –بشكل ما– بطريقة جادة. ليس أمامنا اختيارات؛ لذا فعاجلاً أم آجلاً، سنفعل الصواب.
لكن بعد عامين من التغطية والكتابة عن تكنولوجيا الطاقة النظيفة، ها أنا بدأت أفهم الحقيقة في بطء، وربما لم أفهم. فبينما يمكننا إنجاز الكثير من التحولات المنشودة في ظل توافر التكنولوجيا القائمة أو التي ستتحقق قريباً، فإن معدل التغيير المطلوب وعمق المصالح المُعاندة للتغيير ربما كانا أكبر من القدرة على تحقيق التحرك المنشود.
لذا فإن حريق “كامب فاير” وما أعقبه من أحداث لم يدفعني وحده من حالة التفاؤل إلى التشاؤم، بل كلما زاد فهمي لحقيقة المشكلة، زاد تشاؤمي.
لكن المشهد السُريالي للعمال الذين يجنون أجوراً عالية وهم يسيرون في هواء وسط مدينة سان فرانسيسكو المُصفر بفعل الدخان، والأقنعة المتسقة ألوانها مع ألوان سماعات آذانهم في عاصمة “اليوتوبيا التكنولوجية”، أقول إن هذا المشهد أدى قطعاً إلى توسيع هامش تقبلي بما هو ممكن، وقد كان بمذاق الأحداث المنتظرة في المستقبل.