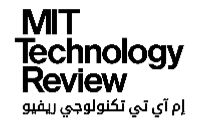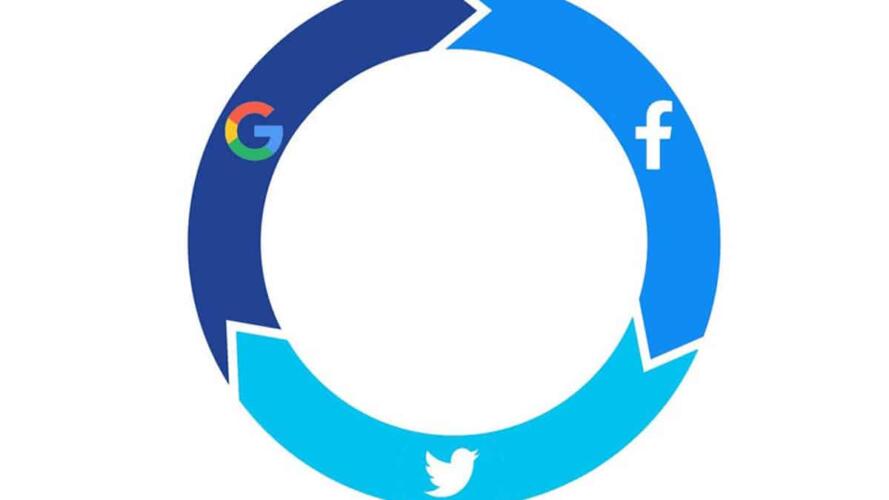
في 25 من شهر مارس/آذار، قدم الرؤساء التنفيذيون لشركات “فيسبوك” و”جوجل” و”تويتر” شهاداتهم أمام مجلس النواب الأميركي حول المعلومات المغلوطة على الإنترنت. كان بالإمكان توقع ما سيحدث حتى قبل انتهاء الجلسة. فبعض أعضاء المجلس سيطالبون منصات مواقع التواصل الاجتماعي ببذل جهد أكبر لمنع الانتشار الكبير والسريع للمعلومات المختلقة من الإضرار بالعملية الديمقراطية وتفجير أعمال العنف، وسيحذر أعضاء آخرون من تقييد حرية الخطاب بلا سبب وسيقولون إنه سيثير غضب العناصر المهمشة ويدفعها إلى اللجوء إلى مساحات لا تحكمها القوانين بنفس الدرجة.
يتكرر هذا الحوار بعد كل أزمة، بدءاً من أزمة مدينة كرايست تشرتش مروراً بنظرية المؤامرة “كيو أنون” وصولاً إلى أزمة “كوفيد-19”. لماذا نعلق دائماً في هذا الطريق المسدود؟ لأن النقاش حول مواجهة المعلومات المغلوطة بحد ذاته قد يخلو من الحقائق؛ نظريات كثيرة وأدلة قليلة. نحن بحاجة إلى خبرات أفضل، وهذا يعني أن علينا تمكين الخبراء.
المعلومات المغلوطة على شبكة الإنترنت
قضى الباحثون عقوداً في دراسة الحروب الدعائية (البروباغاندا) وغيرها من فنون الإقناع السوداء، لكن المعلومات المغلوطة على الإنترنت تشكل منعطفاً جديداً في هذه المشكلة القديمة. فبعد تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016 شهد المجال تدفقاً هائلاً في الأموال والمواهب والاهتمام، والآن يصب أكثر من 460 مركز تفكير وفريق عمل ومبادرات أخرى تركيزهم على هذه المشكلة. ومنذ 2016، فضح هذا المجتمع العالمي عشرات عمليات التأثير ونشر ما يزيد على 80 تقريراً حول أفضل الطرق للتغلب عليها.
تعلمنا الكثير في الأعوام الأربع الماضية، ومع ذلك فإن الخبراء هم أول من يقرّ بحجم ما لا يعرفونه بعد. مثلاً، انتشرت أساليب اختبار الحقائق التي تبين الأبحاث أنها ستوقع أثراً إذا استخدمت بالطريقة الصحيحة، لكن حظر وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من منصاتها يوضح تماماً أين تكمن الفجوات فيها. إن الآثار بعيدة المدى لعمليات الحظر من المنصات لا تزال غير واضحة، ربما ستتلاشى أكاذيب ترامب في الفراغ الرقمي، أو ربما ستخلق معاناته على وسائل التواصل الاجتماعي أساطير تدوم زمناً أطول. الوقت وحده كفيل بكشف ذلك.
هل يعقل ألا نعرف مدى فعالية أمر بسيط جداً مثل حظر حساب على منصة إلكترونية؟ لماذا لم تتوصل أكبر شركات التكنولوجيا في العالم وأهم الباحثين الأكاديميين إلى أجوبة أوضح بعد أعوام من الجهود المركزة؟ لدينا مشكلتان أساسيتان.
تتمثل الأولى في البيانات، من أجل تفكيك العوامل النفسية والاجتماعية والتكنولوجية المعقدة التي تحرك المعلومات المغلوطة يجب أن نراقب أعداداً كبيرة من المستخدمين وهم يتفاعلون مع المحتوى الضار، ثم أن نرى ما سيحدث عندما نستخدم التدابير المضادة له. تملك المنصات هذه البيانات لكن دراساتها الداخلية مشوبة بالمصالح التجارية ونادراً ما يتم كشفها للعموم. لذا يجب إجراء أبحاث موثوقة مستقلة ونشرها للعلن، وعلى الرغم من أن المنصات تشارك بالفعل بعض البيانات مع باحثين خارجيين فإن أهم الخبراء يقولون إن الوصول إلى البيانات لا يزال أكبر صعوبة يواجهونها.
أما المشكلة الثانية فتتمثل في المال. يتطلب الأمر كثيراً من الوقت والموهبة لإنتاج خارطة مفصلة لشبكة اجتماعية أو تتبع تأثير التعديلات الكثيرة التي تجرى على برمجيات المنصة. لكن الجامعات لا تكافئ هذا النوع من البحث العلمي، وهذا يدفع الباحثين للاعتماد على هبات قصيرة الأمد يقدمها عدد قليل من المؤسسات ومحبي الخير، وفي غياب الاستقرار المالي يعانون من صعوبة في التوظيف ويبتعدون عن الأبحاث واسعة النطاق طويلة الأجل. تساعد المنصات في تمويل بعض الأعمال الخارجية لكنها تعاني أحياناً من مخاوف بسبب شعورها بأن استقلاليتها معرضة للخطر.
النتيجة النهائية هي طريق مسدود محبط. ومع تفشي المعلومات المضلّلة والتأثير الضار تفقد الأنظمة الديمقراطية الوقائع الحقيقية التي تحتاج إليها في توجيه ردود فعلها. عرض الخبراء مجموعة من الأفكار الجيدة، مثل رفع مستوى التثقيف الإعلامي وتنظيم المنصات، لكنهم يواجهون صعوبة في إثبات عروضهم أو صقلها.
لكن ثمة حل لهذه المشكلة ولله الحمد، فقد نجحنا من قبل في معالجة مشكلات مشابهة بدرجة كبيرة.
مواجهة المعلومات المضللة
في أعقاب الحرب الباردة، رأت الحكومة الأميركية أنها بحاجة إلى إجراء تحليل موضوعي عالي الجودة لمشكلات الأمن القومي. فبدأت بتقديم الرعاية لنوع جديد من مؤسسات البحث الخارجية تديرها منظمات غير ربحية مثل “راند كورب” (RAND Corp.) و”مايتر” (MITRE) و”مركز التحليلات البحرية” (Center for Naval Analyses). فتلقت مراكز البحث والتطوير التي أسستها الحكومة الفيدرالية أموالاً حكومية ومعلومات سرية، لكنها كانت تعمل بصورة مستقلة. ولذلك تمكنت من تعيين موظفين رفيعي المستوى ونشر أبحاث ذات مصداقية لم تُرض كثيراً من رعاتها في الحكومة.
يجب أن تستفيد شركات وسائل التواصل الاجتماعي من هذا الدليل الإرشادي وتساعد في إنشاء مؤسسة مماثلة لدراسة عمليات التأثير. يمكن لكثير من المنصات جمع البيانات والأموال بالتشارك مع الجامعات والحكومات، ومع استخدام الموارد المناسبة وضمان الاستقلالية يمكن لمركز أبحاث جديد العمل بثقة لمعالجة المسائل الرئيسية المتعلقة بطريقة عمل عمليات التأثير والعلاج الفعال لها. ويمكن جعل البحث عاماً مع إتاحة إمكانية تقليل المخاوف المشروعة فقط مثل المخاوف المتعلقة بخصوصية المستخدم، ولكن ليس من أجل منع الدعاية السيئة.
لماذا ينبغي للمنصات الموافقة على هذه الترتيبات؟
لأن غضب الجهات الرقابية والمعلنين والمستخدمين يضر بأعمالها. ولهذا السبب أنفقت شركة “فيسبوك” مؤخراً 130 مليون دولار لإعداد مجلس رقابة خارجي لإزالة المحتوى ووعدت بالانصياع لأحكامه.
في الحقيقة، لا يزال النقاد يرون أن مجلس الرقابة يعتمد أكثر من اللازم على شركة “فيسبوك”، كما أدى الخلاف الشديد بين شركة “جوجل” واثنين من خبراء الأبحاث في مجال الذكاء الاصطناعي إلى تضخيم المخاوف حول تحكم الشركات بالأبحاث العلمية. إذن كيف للناس أن يثقوا بمركز بحث جديد تربطه علاقات بالمنصات؟ تتمثل الخطوة الأولى بضمان أن يحصل مركز الأبحاث على دعم الجامعات والحكومات إلى جانب عدة منصات بدلاً من دعم منصة واحدة.
ويمكن تشريع مزيد من تدابير الحماية، وثمة دعوة متنامية بالفعل لتحديث المادة 230 من القانون الفيدرالي الأميركي التي تمنح المنصات حماية بالغة الأهمية من المسؤولية. وحتى الرئيس التنفيذي لشركة “فيسبوك” مارك زوكربيرغ أيد ربط تدابير الحماية هذه بشرط رفع شركات التكنولوجيا لمستويات “الشفافية وتحمل المسؤولية والمراقبة“. تتمثل الخطوة العملية بهذا الاتجاه في مطالبة المنصات بمشاركة البيانات مع مركز أبحاث مستقل والحفاظ على علاقة تعاونية وتجارية بحتة مع باحثيه.
إن المعلومات المغلوطة على الإنترنت وغيرها من عمليات التأثير هي من أعظم التحديات التي تواجهها الأنظمة الديمقراطية. لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي إلى أن نفهم هذا التهديد بصورة كاملة، ولا يمكننا الاستمرار بالتحرك من دون هدف واضح إلى الأبد أيضاً. يجب أن نتسلح بالمعرفة كي نخوض المعركة من أجل الحقيقة، ويجب أن نبدأ بذلك الآن.
هذا المقال جزء من مشروع حرية التعبير، وهو تعاون بين مجلة فيوتشر تنس و”برنامج التكنولوجيا والقانون والأمن” (Tech, Law, & Security Program) في كلية واشنطن للقانون بالجامعة الأميركية الذي يدرس طرق تأثير التكنولوجيا في نظرتنا إلى التعبير عن الرأي.